
"بولونيزات": غواية "قضبان" الشوكولاتة السوداء في بلد اشتراكي أبيض
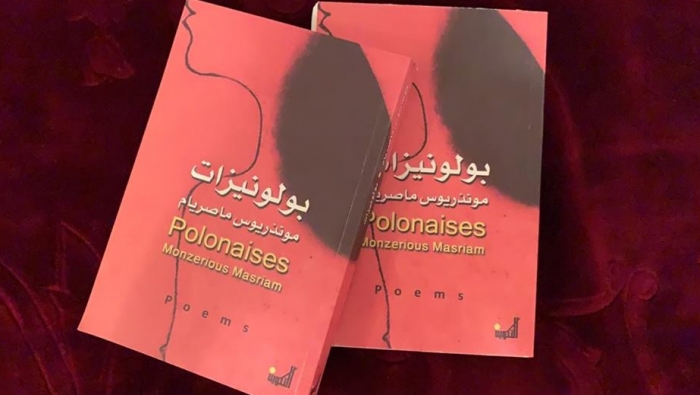
غلاف الكتاب
- الجمعة 8 شباط 2019
ربما من سوء حظ "منذر مصري" أن أياً من زوجات موظفي الرقابة السورية لم تستيقظ باكراً وتقرأ مخطوطة مجموعته الأخيرة "بولونيزات" (دار التكوين- 2018) فتتسبب في بلبلة جديدة لصاحب "ساقا الشهوة"، القصيدة التي منعت لعقود في سوريا، ورغم محاولة منذر "تمريرها" في مجلة "الناقد" البيروتية إلا أن الرقيب نفسه كان له بالمرصاد، فلم تمر.
ولعل العالم قد تغيّر، فمنذر اليوم غير من كان قبل أربعين عاماً، فهو اسم له حضوره في عالم الشعر السوري والعربي، وترجمت له نصوص مختارة إلى الفرنسية والألمانية والإنكليزية، رغم الثقة أن الرقيب نفسه، لو كان حياً يرزق، وسمع بالبولونيزات، لن يخاف من اسم "منذريوس"، ولحاول التدخل ومنعها بشكل أقوى مما فعل سابقاً، فكلما تقدم الرجل في العمر زادت سيطرة "حكومته" عليه، ولعل كل هذا لم يحدث ولم تقدّم المجموعة للرقابة، ولربما، وهو الأهم، أن الزوجات لم يعدن يستيقظن باكراً ويقرأن مخطوطات شعرية أو غير شعرية، ولو بالغلط، فوسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة مغرية للسهر أكثر من الشعر ومن قراءته، وحتى من الشعراء أنفسهم.
شتاء وارسو، باريسُ شرقِ أوروبا
تعود قصائد هذه المجموعة إلى شتاء 1978-1979 (وبعضها قبل عامين من الآن) حين كان "مصري" في بولونيا الاشتراكية سابقاً يتم دورة في التخطيط الإقليميِّ من معهد (أوسكار لانجه) في "وارسو" التي تلقّب "باريس شرق أوربا"، وهذه التفاصيل الدقيقة ـ بما فيها الزمان والمكان والعناوين ـ لن تجدها عند كثيرين، فمنذر مهووس بتدوين أدنى التفاصيل ومدمنٌ على تحويل كل شيء إلى شعر، "إنَّهُ يعتبِرُ صَريرَ الأبوابِ موسيقى، وضجَّةَ الشارعِ في الصباحِ والظُهرِ والمساء، (سوناتا) موسيقيَّةً بثلاثِ حركات، فما بالُكِ بما يعتبِرُهُ شِعراً! (من مقدمة مجموعته).
كتب القصائد كما يقول عن "آنا تاتراكوفا" التي تظهر مرتين فقط في نصوص المجموعة، وبقية الفتيات اللواتي عرفهن وصادقهن تلك الحقبة، ثم وسعها حتى طالت كل ما عاشه هناك مع الأصدقاء والآخرين، كما يقول في تقديم مجموعته، ومن هنا اسم مجموعته التي يجمعها على نسق إنكليزي لنساء تلك البلاد (Polonaises).
يقول منذر في حديث معنا حين اقترحت عليه الكتابة عن المجموعة، أنّه فكّر جدياً بسحب المجموعة بعد طبعها، إلا أن كلفتها العالية دفعته لتجاهل الأمر، لم أسأله سبب تفكيره بسحبها، ولكنَّ قراءة نصوص المجموعة ستدفعنا للقول بأن تفكيره ذاك مرفوض، وإذا كان الشعر ذاتياً في أبهى إشراقاته، كما في قراءته، فإن ما يقدمه منذر في مجموعته هذه، يغمسنا في ثراء وتنوع ذاكرته البصرية والحسية فاتحاً أمامنا كوّةً واسعة في متخيلنا المؤكد عن تلك البلاد، وليس فقط عن نساءها الغارقات في غوايات لا تنتهي ونحنُ نستمتع (أو نشيح بوجهنا رفضاً) أو نتشهى تلك "المنذريات" الدافقة في وديان وجبال أولئك النساء "الحنونات وسط رجال يحملون السكاكين بجنون".
ثلاث مجموعات في واحدة!
يقسم منذر مجموعته إلى أقسام ثلاثة، "بولونزيات"، "من موسكو مع حبي"، "أنصحُكَ بقراءةِ قصائدي على أنَّها أقاصيص"، ليس دون مخطط "مخفيّ" يرتكبه بجمالية في أعماله الشعرية، فالقارئ المتلهف لمعرفة صيرورة (بالإذن من منذر) الرحلة "المنذرية" إلى البلاد البولونية والسوفياتية سيكتشف في آخر الديوان أن الدليل الوحيد على أنه كان هناك بطاقة طلابية وشهادة عليها الكثير من الأختام والتواقيع، وصورة وحيدة مأخوذة "بالغلط"، ليثبت "أنه ليس سائحاً ليلتقط الصور".
يعمل منذر مصري على بناء سردية متصاعدة في حركتها اليومية الزمانية والمكانية، تفاجئك بقدر هائل من بساطتها اليومية وحضورها وقد تحوّلت مشاهدها إلى صور شخصية بالأبيض والأسود ملطخة ببياضه مرات كثيرة (أليست الصورة فاعلاً حقيقياً في المرآة المقابلة للنص؟) بانيةً نسقاً شعرياً لا يمكن الفكاك من أسره بسهولة، وعبر نصوص مفعمة بسردية واثقة، يقودنا في متاهات مدنه البولونية، وفي عوالمها المفتوحة الجهات، صعوداً وهبوطاً مُعيداً ـ أو مختلِقاً كما يقول في تقديمه السابق ـ تلك العوالم إلى حياة جديدة فيها من الخيال كما فيها من الواقع في لعبة تبادلية بيننا وبينه وبمتعة تجعل "لا شيءَ يحدثُ في العالَم يستحِقُّ مجرَّدَ التفاتة".
مع الأجزاء الثلاثة بصفحاتها (262 صفحة)، لن تتوقف كثيراً أول مرة لالتقاط نفَس أمام الصور الدافقة التي يتقن منذر رميها أمامك كقارئ، كل ما تبغيه هو أن تتعرف أكثر على هذا الرحالة العربي في بلاد البولونيزات ـ والبولونزيين أيضاً ـ وهو يطير من مكان إلى آخر، محاولاً معه التوقف، ولو لدقائق عن صعود درج رغبته والتحديق مطولاً في أولئك النسوة وهن يتعرين ـ كشربة ماء ـ ويسكبن كل ما يختزنّ من ألم ووجع ورغبة في أيروتيك مجنون، يقدّم نصائحاً ـ أيضاً ـ للفتيات المقبلات على الحياة (هناك وهنا لا فرق) فالحياة هي "أن تنظر، وترى وتسمع وتشم" وهذه "أهم بألف مرة من أن تضيّع لحظة واحدة بالتقاط الصور".
المفاتيح المخفية
سيكون خديعةً القول إن البولونيزات هي المفتاح الرئيسي لهذا العمل (العاشر لمنذر)، فعلى الرغم من "ثخانة" البورنو البصري المقدام في كل فتوحاته (وفتحاته) في غالب النصوص، فإنه لا يعدو أن يكون قناعاً كبيراً من أقنعة سكان هاواي وبورتوريكو التي يرتدونها أمام زوارهم المفاجئين لاستدعاء القوى السحرية لمقاومة موت أسود (وهل هناك موتٌ أبيض؟) يجري في شرايين تلك المدينة، تلك الكتلة كلها المسماة "كتلةً اشتراكية"، كما البشر الساقطين في لعبة اليومي بغياب فظيع لأي حلم سوى العيش على حدود الكفاف، فساداً وعهراً بمعناه الإنساني لا الجنسي، في عالم يراه الشاعر على حقيقته عارياً من "اشتراكيته" ومن "أيقوناته الثورية المخبأة في ذاك العالم.
تمثّل قصيدة "دعوة مفتوحة لإزالة قبر لينين" واحدة من مفارقات الشعر العربي الجديد بحق، يلتقط فيها بعين الشاعر الناقدة كيف أن:
"أجملِ التقاليدِ الشيوعيَّة
تهدفُ أن يُضيِّعَ الشعبُ نصفَ حياتِه
وهو يقفُ في طوابيرَ طويلةٍ ينتظرُ لا شيء."
أمام باب ضريح كومراد (لينين) حيث ينام الأخير منذ نصف قرن "بثياب يوم الأحد"، وحيث يجب أن ينزل لينين عن صليبه ويدفن إلى جوار "حواريه الثلاثة" فهناك متسعٌ لقبر بالقرب من قبر "ستالين" أيضاً، ويختم: "أرجوكُم
أنقذوهُ من هذهِ الوضعيَّةِ غيرِ المريحة
أوقفوا العملَ بتلكَ اللعنةِ الأبديَّة
أن لا يستطيعَ التقلُّبَ والنومَ على أحدِ جانبَيهِ
مهما طالت فَترةُ تثبيتِهِ على ظَهرِه".
هذه اللعبة الشعرية التي يحوّل "منذريوس" فيها كل لحظة إلى باب مفتوح على مختلف أنواع التأويلات الممكنة في رؤيةٍ شخصيةٍ حاضرةٍ بوضوح في تجواله المفعم بالصدفة في خرائط تلك البلاد، ينتهي بنا نحن المشاهدين في ظل تشابه التجربة السورية إلى حد ما مع تلك التجارب، إلى فرض تقاطع بصري حسي في ذاكرتنا عن حالنا السورية، ربما لا نفاجئ، لكننا على الأقل سنشعر بأن يداً تمحو قليلاً من الغبار عن زجاج وجوهنا هذه الأيام، وهذه يتقن "منذريوس" إيصالها لنا بتقنية السفر فوق الخرائط نفسها: "فيالها من جهنم باردة تلك الجنة التي صنعتموها لهم"، وتصبح "موسكو" الثمانينيات تلك "مقبرة واسعة لحلم البشرية"، يتمها منذر بنص حمل عنوان "ذكرى فتاة من لينينغراد":
"فلا يوجد في النظامِ السوفييتي
مواطنونَ طٌلقاءٌ لهمُ الحقُّ في مغادرةِ أماكنِهِم
والسفرِ إلى هُنا وهُناك
دونَ أن يتقدَّموا بطلبٍ رسمي
تتُمُّ الموافقةُ عليهِ من قِبلِ الجهاتِ المُختصَّة
تُحدَّدُ بهِ مُدَّةُ السفر".
يمكن أن تقرأ العبارة السابقة في أي تحقيق صحفي، أو ربما في خبر تلفزيوني، لكن على الأكيد سيستبعد منه الحمولة الشعرية ما إن تُخرجه من "بيته" إلى هذه المادة، "دوريمي" في النص السابق، امرأة من لحم ودم وحلم مهدور، وهي ضحية دون شك، تجعل حملها للورقة المكتوب عليها ما سبق، نصاً فوق الشعر بمعناه السماوي أو الأرضي، وتكتفي أنت القارئ المواجه لصورة منذر بالتفكير ملياً بالأحلام التي احترقت على الجهة المقابلة لأوروبا الاشتراكية تلك، يكتب في رده على رسالة لصديقه:
"آخ يا مصطفى، أنتَ تعلم دائماً
عِندَما يحترِقُ طرفُ الخريطةِ
تحترِقُ الخريطةُ كُلُّها".
الأيروسية الخادعة مرة أخرى:
في متون النصوص كلها هناك "إيروسية" بصرية دافقة، حاضرةً تدور حتى في فلك نصوص الاحتجاج الجافة النقاش والعقل، لاعبةً في مداها المفتوح المتحرر من مختلف أنواع الرقابة المجتمعية (المشرقية ربما في ذاكرتنا)، تُذكّرك كقارئ وبلا وعي متقصّد (ربما مرة ثانية) بفتوحات بطل الطيب صالح في روايته الأشهر (موسم الهجرة إلى الشمال)، فنصوص منذر يمكن قراءتها كقصص ـ مرة جديدة كما يقول هو، فهناك أولاً من يشاركه فتوحاته السوداء تلك بقليل أو كثير من التباهي الذكوري الذي يتقنه ذكور الشرق بمختلف أنواعهم أمام نساء بياض الثلج.
هذه "ثيمة" متكررة في الأدب العربي لا شك، إلا أنها عند منذر تأخذ أبعاداً أكثر واقعية وحدّة في ظل تغيير دائم للشخوص والأمكنة والتنقل من عتبة بصرية وسمعية إلى أخرى، ومن حديث إلى آخر، ومن لقطة إلى أخرى، ومن صورة إلى أخرى أكثر دلالة وأكثر غرابة، وإن كانت كلها تتخفى في ثياب سرديات نثرية يعتبرها منذر ونقاده متنه الشعري الأصدق وقاموسه المتكوّن من لغة الناس العاديين.
الإيروسية في نصوص منذر، حقيقة لا تتخفى وراء غاية ولا توظف المفردة بغير غاية، فهي إيروسية لأنها كذلك، ولأن الحدث كذلك، ولا يمكن ـ ولا يرغب ـ بتغليفها بمعادل لغوي يناسب قارئه (قراءه)، فلا مواربة خلف الأقنعة إلا حيثما تقتضي ضرورة السرد، مقدّماً أمامنا دون قلق أو غموض، (الغموض مرادف أكيد للقلق) حُرّاً كما هو، إنساناً يتمحور حوله النص والعالم والرغبة الدافقة بتأكيد متبادل على / ومع الآخر الحاضر على شهوانية إنسانية وليس فقط أمام الأنثى الشهوانية المفرطة في بلاد الثلج.
لا يوجد في نصوص "البولونيزات" أية أقنعة جنسية بالمعنى الشعري العربي المتداول، فلا إشارات ولا رموز ولا أحلام مكبوتة، كل ما تصطدم به واقعي إلى درجة الجرأة، هذا لا يقلل من جمالية السرد "المصري" بقدر ما يخفف عنه عبء تحميله وزر اجتهادات نصية لا مبرر لها في غالب الشعر الجديد وسط كل الدفق الهائل في الميديا والحياة، هل لعنة الواقعي أقلُّ أثراً من لعنة المتخيل؟ بالتأكيد لا يفكر منذر بهذه المقارنة ولا يخرج عن إطار مشروعه الشعري في "شعْرنة" كل شيء، بما في ذلك "قلي البيض مع السجق" التي تحتمل تفسيراً تأويلياً بلغة الذكور، مثلها مثل: (قضبان الشوكولاته السوداء- مغنطيسي في حدائدها)، ولكنها بالمقابل لا تبُعد كثيراً عن معناها الموارب الواضح.
اليهوديات أيضاً لديهنّ رغبات:
تغيب المرأة ـ الأنثى ـ اليهودية (كما الرجل) غالباً عن عوالم الشعر السوري (وربما العربي عدا الفلسطيني)، وهذا طبيعي في ظل قطيعة نفسية ومجتمعية وسياسية، ولكن في وارسو حيث يوجد عدد من اليهود فإن الاحتكاك (الفيزيائي) أمرٌ وارد.
يلتقط منذر هذا التواجد بلغة مختلفة هي لغة الرجل ـ المرأة في صيرورة التحول من نمط التقابل العدائي القبْلي إلى المدى الإنساني دون غفلان تلك اللقطة التي يغصّ بها منذر حين يوقع على أوتوغراف لفرقة اليدتش اليهودية وهي تعيد أسطرة الصورة اليهودية عن محارق النازية في وارسو كما في موسكو.
العلاقة المتاحة في نصوص "البولونيزات" اليهوديات تنطلق وتنتهي من قلب اليومي مع حمولات صراعية مرتبطة بالتفكير بالانتقال إلى فلسطين هرباً من النظام الشيوعي المستبد ـ ربما ـ إلى الجنة الموعودة دون كثير أسئلة أو معرفة عن مآلات ما بعد الحدث، وهذه لا تدخل في سياق التضاد المعرفي، بل تكتفي بالمراهنة على اليومي مرة أخرى، وعلى علاقةٍ جنسية عابرة، لا بأس في أن ينتقم فيها الفلسطيني من نساء محتليه.
خلاصات مؤقتة:
لا يوجد في الشعر خلاصات، ولا توجيهات، ولا شيء سوى أن تقول كقارئ (يحاول أن يكون حيادياً) إن هذا النص قد حقق لديك متعةً ما، لا يهم كيف حصل ذلك، فبعض الأمور تبقى في نطاق التلقي عاريةً من التفكير في أسبابها، كذلك هي هذه المجموعة لمنذر مصري، بالنسبة لي كقارئ على الأقل يحاول استقراء نص يدّعي البساطة ولكنه غير ذلك حقاً، ليكون في النهاية أن العمل ككل يستحق أن يُقرأ وبهدوء ... على الأقل مرة واحدة في الصباح الباكر.
